أ.د. فؤاد عبد المطلب: نقد روايةِ “أخناتون ونيفرتيتي الكنعانية” لصبحي فحماوي حسبِ التصنيفِ الجنسيّ والعرقيّ
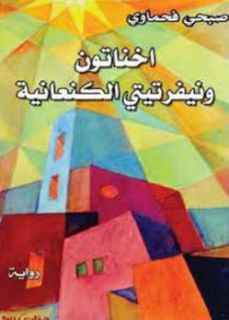
الإنتشار العربي :أ.د. فؤاد عبد المطلب
يقولُ أحدُ الدّارسينَ إنَّ الروائيَّ صبحي فحماوي ” قد تمكنَ من تقديمِ دراسةٍ معلوماتيَّةٍ وفنيَّةٍ للتاريخِ بمنهجيَّةٍ أدبيَّةٍ وببلاغةٍ تتوفَّرُ فيها أركانُ التشويقِ للنصِّ الروائيِّ.”( )
يهتمُّ جزءٌ كبيرٌ من النّقدِ المعاصرِ على نحوٍ خاصٍّ بقضايا التصنيفِ الجنسيِّ والإثنيِّ والعرقِ وبتأكيدِ علاقاتِ القوَّةِ. وفي عامِ 1975 أكَّدتْ هيلين سيسو في كتابِها “ضحكةُ ميدوسا” أنَّ “المرأةَ يجبُ أنْ تكتبَ ذاتَها”. وربَّما يعودُ الفضلُ إليها في أنَّها أولُ منِ استعملَ مصطلحَ “الكتابةِ النِّسويَّةِ” بالفرنسيَّةِ Ecriture Féminine. وتبدُو دعوةُ سيسو مهمَّةً في ظلِّ تعاظمِ دورِ المرأةِ في العالمِ الحديثِ والمعاصرِ أمامَ عالمٍ تهيمنُ عليه الخطاباتُ الذكوريَّةُ. ليسَ هذا فحسبُ، بل تأتي دعوةُ سيسو في خضمِّ تطوُّراتِ وتحوُّلاتِ الكتابةِ النِّسويَّةِ المغايرةِ للكتابةِ الذُّكوريَّةِ، وهو ما شكَّلَ لبناتِ الخطابِ النِّسويِّ الجديدِ.( ) ويشيرُ معظمُ نقَّادِ هذا الاتِّجاهِ، في معرضِ حديثهِمْ عن قرَّاءِ الرواياتِ، النّساءِ منهم خصوصاً، أنَّـهُ يتمُّ “تذكيرُ” هؤلاءِ القرَّاءِ، لأنَّـهُم يقرؤونَ بصورةٍ تقليديَّةٍ أيْ كما تَعَلَّمُوا بكونِهم ذكوراً جميعاً. وفي نهايةِ السّبعينيَّاتِ من القرنِ الماضي، كتبتْ مثلًا جوديث فيترلي أنَّـهُ يجبُ على النِّساءِ الشُّروعُ في تحريرِ أنفسِهنَّ من فكرةِ القارئِ العامِّ، وهو في الحقيقةِ ذَكَرٌ، وحذَّرتِ النِّساءَ من التماهي مع وجهاتِ النَّظرِ الذكوريَّةِ في القراءةِ، ودعتْ إلى تطويرِ نماذجَ قرائيَّةٍ نسويَّةٍ خاصَّةٍ( ) تستندُ أساساً إلى التصنيفِ الجنسيِّ. ويستدعي هذا الموقفُ النَّقديُّ رأياً وسؤالاً أبدَاهُ جوناثان كالر أيضاً: ما الذي يعنيهِ كلامُ أنْ نقرأَ “بكونِنا نساءً” وكيفَ يمكنُ أنْ تتغايرَ “القراءةُ بكونِنا نساءً” عنِ “القراءةِ بكونِنا رجالاً”؟ وما الذي نعرفُهُ أساساً عن معنى أنْ نقرأ “بكونِنا رجالاً”؟( )
ويمكنُنا ههنا أنْ نطرحَ السُّؤالَ الآتيَ للمناقشةِ حولَ إمكانيَّةِ قراءةِ روايةِ فحماوي قراءةً تتعلَّقُ بالتصنيفِ الجنسيِّ. فالراوي بالنّسبةِ إلينا عموماً أو افتراضياً رجلٌ أو ذَكَرٌ؛ ألا يحقُّ لنا من وجهةِ نظرٍ تصنيفيَّةٍ أنْ نقولَ بأنَّـهُ إمرأةٌ لا رجلٌ، ولمَ هو رجلٌ أساساً؟ ولمَ الرِّوايةُ افتراضاً حولَ شخصياتٍ ذكوريَّةٍ أكثرَ ممَّا هي حولَ شخصياتٍ نسويَّةٍ؟ أليسَ من الإجحافِ أنْ تُقرَأَ بوجهةِ نظرٍ ذكوريَّةٍ. أليستِ الرِّوايةُ أيضاً حولَ شخصياتٍ نسويَّةٍ، الملكةُ الأمُّ مثالٌ والأميرةُ إلهامُ وأختُها موت نجمت، والَّتي تعاني من الإهمالِ يكونُ لها دورٌ مؤثِّرٌ في حياةِ نفرتيتي فيما بعدُ، والملكةُ الأمُّ تيي وابنُها أخناتون، وقريباتُهنَّ من النِّساءِ، ويجبُ أنْ يَظهرنَ في القراءةِ، وفي أحداثِ الرِّوايةِ أيضاً. ألا يمكنُنا بكونِنا قراءً أو نقَّاداً الولوجَ إلى عالمِ الرِّوايةِ من فكرةِ الاختلافِ الجنسيِّ في الواقعِ كما في الرِّوايةِ، بالنَّظرِ إلى علاقاتِ القوِّةِ بينَ الرجالِ والنِّساءِ، واستجابةِ القارئِ النّقديَّةِ ذكوريَّةً كانتْ أم نسويَّةً؟ وبإمكانِنا حقيقةً مساءلةُ النّصِّ أيضاً بقراءةٍ غيرِ ذكوريَّةٍ لأحداثٍ ومشاهدَ وعلاقاتِ قوَّةٍ في الرِّوايةِ أغلبُ صانعِيها نساءٌ لا رجالٌ، هذا معَ أنَّ المحيطَ الاجتماعيَّ ذكوريٌّ لا يحفلُ كثيراً بالمرأةِ ودورِها السِّياسيِّ والاجتماعيِّ والاقتصاديِّ. ويمكنُنا مثلاً قراءةُ شخصيَّةِ الملكةِ الأمِّ تيي المتمرِّسةِ في الإدارةِ، تقولُ ناصحةً أخناتون ونفرتيتي:
“لا داعيَ يا ولدايَ لمصادمةِ رجالِ الدِّينِ، فهمْ جماعةٌ لا يُستهانُ بهم، إذ يستندونَ في قوَّتِهمْ إلى خالقِ الكونِ. ومتسلِّحونَ بالإلهِ آمون. الذي يعبدُهُ الشَّعبُ كلُّهُ، ولا يسمحونَ بتحطيمِ مثُلِهمُ العليا بهذه السُّهولةِ. هؤلاءِ قومٌ وجدُوا آباءَهمْ يعبدونَ الإلهَ آمون، فبقُوا له عابدينَ. النَّاسُ يا ولدي لا تحبُّ التَّغييرَ. فمن يحبُّ آمون سيبقى يعبدُهُ. خاصَّةً وقد تقودُ كهنتُهُ على التكاتفِ تقليدياً مع الفرعونِ لعبادتهِ، وهمُ المستندونَ على ثرواتِهمْ وممتلكاتِهمْ، الَّتي يستطيعونَ أنْ يشترُوا بها معظمَ النَّاسِ.”( )
واهتمَّ النّقدُ الحديثُ أيضاً بقضايا العرقِ والإثنيَّةِ والقوميَّةِ وطوَّرَ تقنيَّاتِ قراءةٍ خاصَّةٍ، وتناولَ القراءةَ أيضاً. وقامَ مُنَظِّرونَ من أمثالِ فرانز فانون وغياتري تشاكروﭭرتي سبيـﭭـاك وهنري لويس غيتس الابن وإدوارد سعيد وغيرِهمْ، بتطويرِ طبيعةِ الدِّراساتِ الأدبيَّةِ المعاصرةِ بتأكيدِ قضايا الاستعمارِ، والاختلافِ الإثنيِّ، والاضطهادِ العرقيِّ، والتمييزِ العنصريِّ، وأوضاعِ الأشخاصِ التَّابعينَ أوِ المهمَّشينَ، والغربِ وبنائِهِ نظرةً دونيَّةً إلى الآخرِ خاصَّةً، ومختلفِ قضايا الاستشراقِ والإمبرياليَّةِ. فعلى سبيلِ المثالِ، يناقشُ إدوارد سعيد فكرةَ ما أُطلِقَ عليه “القراءةُ الطِّباقيَّةُ” Contrapunctum، وتعني أساساً “المقابلةَ” وتشيرُ إلى تشابكِ الأصواتِ الموسيقيَّةِ المتنوِّعةِ بتشابهاتِها واختلافاتِها. ووظَّفَ سعيد هذا المصطلحَ نقدياً في دراسةِ صورةِ الهويَّةِ القوميَّةِ والإثنيَّةِ والدّينيَّةِ، وأشكالِ الهيمنةِ والقمعِ الاستعماريِ، وفي علاقةِ الغربِ بالشّرقِ، وتأكيدِ الاختلافِ في الهويَّاتِ في قضيَّةِ التعايشِ السِّلميِّ. ويمكنُ بالقراءةِ الطّباقيَّةِ فهمُ العلاقةِ المركَّبةِ بينَ الثَّقافةِ والاستعمارِ، والَّتي يمكنُ بها قراءةُ نصٍّ حيثُ ينفتحُ الطَّريقُ “إلى ما يريدُهُ النّصُّ، وإلى الشَّيءِ الذي استبعدَهُ المؤلِّفُ”( )، ويمكنُ أنْ توحيَ قراءةُ الكثيرِ من الرواياتِ من نظرةٍ عرقيَّةٍ أو قوميَّةٍ أو وجهةِ نظرٍ حولَ العبوديَّةِ بقراءةٍ “طباقيَّةٍ” من هذا النَّوعِ. وعلى غرارِ إدوارد سعيد، يثيرُ هنري لويس غيتس أسئلةً أساسيَّةً حولَ النّظريَّةِ والنَّقدِ الأدبيِّ الأسودِ، أيِ الأفريقيِّ- الأمريكيِّ، ويناقشُ أنَّ السُّودَ في الولاياتِ المتحدةِ عليهم أنْ يطوِّرُوا خططاً خاصَّةً للقراءةِ والتفسيرِ لو أرادُوا البقاءَ على قيدِ الحياةِ:
كانَ السُّودُ دائماً أساتذةً في الصُّورِ البلاغيَّةِ: يقولونَ شيئاً فيعنُونَ شيئاً آخرَ تماماً وهذا أساسيٌّ بالنِّسبةِ إلى بقاءِ السُّودِ على قيدِ الحياةِ ضمنَ ثقافاتٍ غربيَّةٍ مضطهِدةٍ لهم. فسوءُ قراءةِ الإشارةِ قد يكونُ، كما حدثَ غالباً بالفعلِ، أمراً يؤدِّي إلى التهلُكةِ. ’القراءةُ‘، بهذا المعنى، ليست لعباً؛ بل مظهراً أساسيَّاً من مظاهرِ تدريبِ الطِّفلِ على ’التعلُّمِ‘( ).
وعليه، قراءةُ روايتِنا من وجهةِ نظرٍ عرقيَّةٍ أو قوميَّةٍ يمكنُ أنْ تبدأَ من حقيقةِ أنَّ هذه الرِّوايةَ العربيَّةَ تتناولُ أو تصوِّرُ الآخرَ المختلفَ إثنياً أو قوميَّاً أو ثقافيَّاً – المصريَّ والكنعانيَّ القديمينِ – وتحاولُ استكشافَ العلاقةِ بينَ ’الأغيارِ‘ صراحةً أو مواربةً. فمثلاً، كونُ الأرضِ المصوَّرةِ في الرِّوايةِ في معظمِها مصريَّةً قديمةً، فرضياً يُلغي إمكانيَّةَ بروزِ حضارةٍ أو ثقافةٍ عصريَّةٍ مستمرَّةٍ فيها، وأوحتْ هذه الأرضُ بملامحِها التَّاريخيَّةِ القديمةِ الَّتي كانتْ موجودةً عليها. فبالنِّسبةُ إلى هذه الرِّوايةِ، تشخِّصُ مصرَ فقط بكونِها ماضياً غابراً، لكنَّ القراءةَ التفسيريَّةَ قد توحي أو تقترحُ أشياءَ حديثةً أيضاً.
منزلة رواية فحماوي في وصف التاريخ الذي تقصده:
لا بدَّ من القولِ إنَّ الرِّوايةَ لا توثِّقُ الأحداثَ فهذا شأنُ المؤرِّخِ، لكنَّها صادقةٌ في التعبيرِ عن مجرياتِ الحياةِ في الماضي والحاضرِ والمستقبلِ، وعن ضميرِ الأمَّةِ الجمعيِّ، بفنِّها المتعدِّدِ الأطيافِ وهذا ما لا يستطيعُهُ المؤرِّخُ. فالمنظارُ في روايتِنا يوحي بعملِ المؤرِّخِ المعلوماتيِّ الذي ينقلُ بالصورةِ والصَّوتِ بعداً واحداً لِمَا يحدثُ أمامهُ، والراوي أوِ المؤلِّفُ يرى بعينينِ موهوبتينِ مناظرَ متعدِّدةَ الأبعادِ. وأخبرَ اللهُ تعالى في القرآنِ الكريمِ، على سبيلِ المثالِ، بأسلوبٍ قصصيٍّ فريدٍ في نقلِ حوادثِ التَّاريخِ، عنِ الأممِ المصريَّةِ والكنعانيَّةِ والبابليَّةِ والعربيَّةِ القديمةِ وغيرِها، فكانَ التوظيفُ غايةً في الإيجازِ والتعبيرِ والإقناعِ.
أخيراً لا آخراً، إنَّ قراءةً بعدَ بنيويَّةٍ أو تفكيكيَّةٍ لهذه الرِّوايةِ، يمكنُها، بالإضافةِ إلى الاهتماماتِ السَّابقةِ، أنْ تتقصَّى تشتُّتَ أو ذوبانَ هويَّةِ القارئ في فعلِ القراءةِ، وأنْ تثبتَ الإحساسَ بالغيريَّةِ الجذريَّةِ الَّتي تُلغِي ادِّعاءاتِ السِّيادةِ التفسيريَّةِ كلِّها. وبالنّسبةِ إلى نقَّادِ بعدَ البنيويَّةِ هناكَ دلالةٌ حيويَّةٌ لقضيَّةٍ أساسيَّةٍ حولَ مَنْ يأتي أولاً – النّصُّ أمِ القارئُ؟ وهلِ القراءةُ ببساطةٍ أمرٌ طارئٌ يحدثُ للنصِّ بمحضِ المصادفةِ، أيُّ أمرٍ طارئٍ يحدثُ للنصِّ لكنَّهُ يتركُهُ ثابتاً على نحوٍ جوهريٍّ؟ وإذا كانَ الأمرُ كذلك، فإنَّ دورَ القارئِ سيظهرُ كأنَّ النّصَّ حدَّدَهُ: بمعنى أنَّ كلَّ نصٍّ أدبيٍّ مجموعةٌ من الإرشاداتِ أو صفةٌ لمكوِّناتٍ، يمكنُ للمرءِ الاطِّلاعُ عليها كي يقرأَهُ. وبالمقابلِ، يفيدُنا هذا الأمرُ أنَّ النّصَّ غيرُ مكتملٍ أساساً، لكنَّهُ يُنمَّى بفعلِ القراءةِ نفسِهِ. ففي هذه الحالةِ تتمُّ إعادةُ بناءِ النّصِّ من جديدٍ في كلِّ قراءةٍ. وإزاءَ هاتينِ الفرضيتينِ في القراءةِ، تناقشُ النَّظراتُ التفكيكيَّةُ في القراءةِ أنَّ كلا النَّموذجينِ نافعٌ فيمكنُ الإفادةُ منهما، ففي قراءةٍ مزدوجةٍ خاصَّةٍ، يقومُ النّصُّ بصنعِ القارئِ كما يقومُ القارئُ بصنعِ النّصِّ. فالتفكيكيَّةُ تحاولُ استكشافَ الحيِّزِ بينَ هاتينِ الإمكانيَّتينِ، وتسعى إلى أنْ تشيرَ إلى الطُّرقِ الَّتي تغدُو بها كلُّ قراءةٍ ونصٍّ شيئاً لا يمكنُ التنبُّؤُ أوِ البتُّ فيه. ويعني ذلك أنَّ عمليَّةَ التفكيكِ تهتمُّ بحقيقةِ أنَّ أيَّ نصٍّ يتطلَّبُ “قراءةً دقيقةً أو أمينةً”، واستجابةً فرديَّةً خاصَّة أيضاً. ولو عبَّرنْا عن هذا المعنى بكلماتٍ أخرى، لَقُلْنا إنَّ القراءةَ بذاتِها بدايةٌ مفردةٌ، أي قراءةٌ شخصيَّةٌ محدَّدةٌ، وهي أيضاً عامَّةٌ، تتماشى مع أنساقِ المعنى الَّتي يفرضُها النّصُّ – النّصُّ الذي لا يطلبُ شخصاً محدَّداً بالذاتِ كي يمارسَ وظيفتَهُ، بل أيَّ شخصٍ من دونِ تعيينٍ. فعبرَ النَّظرِ في هذه التعارضاتِ وتحليلِها، يقترحُ بعضُ النقَّادِ التفكيكيُّونَ أمثالُ بول دومان وجي. هيليس ميلر طرقاً قد تبدُو فيها القراءةُ غريبةً، وغيرَ مستقرَّةٍ، حتَّى مستحيلةً( ).
وتماماً كما تساءَلْنا سابقاً إلى أيَّةِ درجةٍ يستطيعُ المنظارُ أنْ يقرأَ مشاعرَ الملكِ أوِ الملكةِ أو قائدِ الجيشِ أو كبيرِ الكهنةِ، فإنَّنا لا نستطيعُ التهرُّبَ من حركيَّةِ القراءةِ والتورياتِ والانتقالِ من نغمةٍ إلى أخرى. إنَّنا باختصارٍ لا نستطيعُ التوقُّفَ عنِ القراءةِ لأنَّنا لا نعلمُ في النّهايةِ أنَّ ما يظهرُ أمامَنا في هذه الرِّوايةِ نقرؤُهُ نحنُ أم يقرؤُنا. ويجبُ ألَّا يقودَنا هذا الاقتراحُ إلى الاستسلامِ أوِ اليأسِ أو اللامبالاةِ أوِ الشُّعور بعبثيَّةِ القراءةِ. بيدَ أنَّ هذا الأمرَ يجعلُ وجودَنا وهويَّاتِنا وموقفَنا دائماً على المحكِّ. وإذا، كما ناقشْنا في البدايةِ، كانتْ “أخناتون ونفرتيتي الكنعانيَّةُ” أساساً حولَ القرَّاءِ والقراءةِ الروائيَّةِ التَّاريخيَّةِ، كحالِها في قضايا أخرى، فإنَّنا قد نرى العلاقةَ بينَ القراءةِ نفسِها وكونِنا نقرأُ النّصَّ تتحوَّلُ على نحوٍ غريبٍ: فنحنُ لا نقرأُ الرِّوايةَ وحدَنا بلْ تقرؤُنا أيضاً، فتُغرِينا أو تحثُّنا على الإفصاحِ عمَّا يجولُ في خواطرِنا من آراءٍ، وما يعتملُ في قلوبِنا من عواطفَ وانفعالاتٍ. فمثلُ شخصيَّتي أخناتون ونفرتيتي نفسَيهما، نبرزُ ونتداعَى ونصمتُ ونمضي: فتُقرَأُ أفكارُنا وانفعالاتُنا، وربما تهكَّمَ عليها الراوي أوِ انتقدَها، وتجنَّبَها المنظارُ أو ركَّزَ عليها، ضمنَ شكلِ الرِّوايةِ نفسِهِ.
وبعدَ قراءةِ روايةٍ كهذه ما الذي سنفعلُهُ إزاءَ هذه القضايا المثارةِ، في قراءتِنا لها، وهل نستطيعُ مثلاً تجاهلَ كلماتِ أخناتون وابتهالاتِهِ، سواءٌ الصامتةُ منها أوِ المنطوقةُ: “أتون الشَّمسُ سيرسلُ أشعَّتَهُ إلى الجميعِ في مصرَ وبلادِ كنعانَ والعالمِ كلِّهِ… أوِ”الشَّمسُ مصدرُ الحياةِ..” كيفَ نقرأُ هذا القولَ ونقارنُهُ مع “اللهُ نورُ السَّماواتِ والأرضِ….”؟ وما الذي يستدعيهِ ذلك في تفكيرِنا؟ وكيفَ نعبِّرُ عمَّا يستدعيهِ من أفكارٍ وعواطفَ ومقارناتٍ بعدئذٍ؟ أليسَ من الحريّ بنا أنْ نقرأَهُ في ضوءِ ما كتبَهُ المؤلِّفُ عندما يتدخَّلُ ليرثيَ نهايةَ أخناتون ويعلِّقُ عليها:
وأخيراً تهاوى الشَّاعرُ المبدعُ وهو يبني أهراماً للحضارةِ الإنسانيَّةِ، غيرِ القائمةِ بنهشِ أكتافِ الآخرينَ. المسكينُ. لم يكدْ يُتِمُّ الثلاثينَ من عمرِه.. حتَّى توفِّيَ محطَّمَ القلبِ، بعد أنْ أدركَ عجزَهُ عن تحقيقِ آمالِهِ بتغييرِ العلاقاتِ الإنسانيَّةِ على وجهِ الأرضِ.. ماتَ الإنسانُ الذي انبثقَ من وسطِ الفسادِ، نقيَّاً طاهراً، حالماً بتحقيقِ جنَّةٍ على الأرضِ. ماتَ النَّبيُّ الذي جاءَ ليخلِّصَ النَّاسَ من الاستعبادِ والابتزازِ والنَّهبِ والسَّلبِ باسمِ آلهةٍ لا تُطعِمُ خبزًا ولا تمنحُ الحمايةَ لحيوانٍ أو بشرٍ.. ماتَ الملكُ أخناتون محطَّمَ القلبِ .. بعد أنْ أدركَ أنَّـهُ لم يعُدْ مقبولاً لدى شعبِهِ، وأنَّ شعبَهُ غيرُ جديرٍ بهِ. ماتَ واندثرَ بلا مراسمِ جنازةٍ تليقُ بمقامِهِ، ولا بأغانٍ جنائزيَّةٍ من أشعارِه الَّتي هزَّتِ الفكرَ الكونيَّ، ووصلتِ السَّماءَ بالأرضِ.( )
جامعة جرش


